- Home
- Articles
- Radar
في منزل عائلة نازحة من دير الزور إلى دمشق
تضع سارة الكمامة على وجهها وتتابع بعينيها: شارع طويل على جانبيه أكوام من القمامة المكدسة المشتعلة بدخان أسود، بأبنية غير منتهية البناء (على العظم)، بعض الأطفال يلهون على مواد البناء المبعثرة هنا وهناك، وحدها قطع الثياب المنشورة على حبال الغسيل في بعض الشرفات ما يمنح ذلك المكان شيئاً من اللون.
كمعظم شوارع جرمانا الطرفية محفور بطريقة هندسية تجعل من العسير على أي سيارة الدخول إليه، حتى سيارة القمامة.
تفكر بأن وحشاً ما امتص الألوان من المكان أو حوله إلى رماد، حين تتابع سيرها خلف الفتاة النازحة الناجية من الموت في مكان آخر. سارة تعمل متطوعة مع إحدى الجمعيات الخيرية، مهمتها زيارة المنازل التي تزودها الجمعية بعناوينها لتقييم حالتها؛ بعض العناوين تكون معقدة، فتأخذ موعداً ويأتي أحد أفراد الأسرة لاصطحابها. الفتاة التي جاءت هذه المرة لاصطحابها جميلة وصغيرة لم تخمن أنها أرملة وأم لطفلين خسرت أحدهما في الحرب "والله مات، كان عمرو سنتين" ثم تتلعثم، لا تريد أن تتحدث عن الأمر أكثر خشية أن تقول ما قد يحمّل النظام مسؤولية موته.
انتقلت العائلة منذ فترة قصيرة إلى هذا المنزل المكسو بعد أن كانت تسكن في بيت على العظم، فمرض الأب بذات الرئة جعلهم يتكبدون مزيداً من الأموال القليلة لدفع إيجار منزل بأبواب وشبابيك. مات الأب قبل أن يكمل الخمسين من العمر بسبب الفقر والعجز عن تأمين الدواء ومستلزمات العلاج. تأخرت الجمعية كثيراً قبل أن تعطي رقم العائلة لسارة التي وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه، فالعائلة المهجرة من دير الزور طلبت قبل ثلاثة أشهر مساعدة في علاج الأب، قبل أن يموت الرجل الذي كان يعيل خمس نساء وثلاثة أطفال.
تجلس سارة على فراش إسفنجي في منزل واسع مفروش بحصيرة. لا براد ولا غسالة ولا غاز. تسأل سارة كيف تطبخون؟. "والله عالسخانة بس تجي الكهربا، شوفة عينك".. وتفكر بكل الحرائق الناتجة عن ماس كهربائي. "فيكن تعطونا غاز وجرة؟" تجيب سارة ما حفظته في الجمعية، فمؤخراً -ونتيجة أزمة الغاز والبطاقة الذكية- لم تعد الجمعية تستطيع تقديم هذه الخدمة. "شو بتقدموا؟" تسأل الأرملة الأم "شوفة عينك ما عندنا شي، والشايب مات مديون".
تنظر سارة حولها وتطلب القيام بجولة في المنزل، ثم تقترح عليهم أن يطلبوا سجادة كمساعدة عينية، تصمت الأم ثم تسأل "في براد؟ ولو زغير ومستعمل، الدنيا جاية على رمضان وصيف"، تجيب سارة مجدداً مما حفظته، بأن سقف المساعدة في الجمعية لا يسمح بالبراد، ثم تنتبه إلى السواد الذي تتشح به العائلة التي ما زالت في فترة حداد، وتتمتم "العين بصيرة والايد قصيرة". تطلب دفتر العائلة وتسجل البيانات على عجل فالنظرات كانت موجعة، حتى وإن كانوا يعلمون بأنها مجرد متطوعة لا تحل ولا تربط، ولكنهم كانوا يرجونها بأن تحننْ قلوب المانحين عليهم في تقريرها.
تخرج سارة من المنزل خلف ذات الفتاة التي اصطحبتها بصمت، هذه المرة صار لها اسم، ليلى. ليلى التي فقدت زوجاً وابناً في دير الزور، ورفضت الحديث عن الأمر، والتي تلبس الأسود مجدداً حداداً على والدها. تمشيان في ذات الطريق الذي حوّله مطر نيسان الخفيف -الذي تقاطر أثناء زيارتها- إلى نهر من الوحل.
تخجل هذه المرة من وضع الكمامة أثناء عبورها عباب الدخان الأسود الذي لم يخمده المطر بل زاده تدخيناً. يغرق حذاؤها في الوحل، وتفكر بأن الجمعية التي تمنحهم بدلاً بسيطاً عن الاتصالات والمواصلات، يجب أن تمنحهم بدلاً عن الأحذية المهترئة. ستخبر معارفها بتلك الفكرة، تتدارك نفسها وتفكر في وجدانها الذي تبلد منذ بدأت هذا العمل، وتشعر بالذنب فربما كانت السجادة نافعة قبل ثلاثة أشهر للرجل الذي مات برداً ومرضاً وقهراً.
تواسي نفسها بأنها لم تكن سبب التأخير، فقد زارت العائلة فور حصولها على الرقم. ثم تفكر في كمّ الأوراق التي ستملأها لتستطيع إقناع الجمعية بمنحهم سجادة، والصيف قاتل -كما كل شيء في هذا البلد- خلف الأبواب


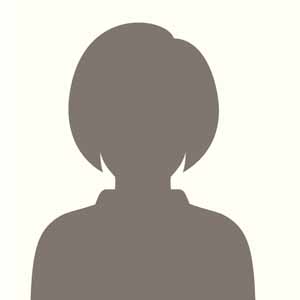 ريّا فارس
ريّا فارس



